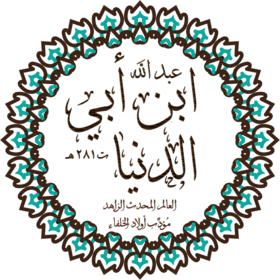ابن أبي الدنيا
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. لو كنت أنت المحرر الذي أضاف هذا القالب وتُحرر المقالة بشكلٍ نشطٍ حاليًّا، فضلًا تأكد من استبداله بقالب {{تحرر}} في أثناء جلسات التحرير النشطة. آخر من عدل المقالة كان Mr.Ibrahembot (نقاش | مساهمات) منذ 22 ساعة (تحديث) |
| العالم المحدث الزاهد | |
|---|---|
| ابن أبي الدنيا | |
لقب ابن أبي الدنيا بخط الثلث.
| |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | 208 هجري ق. 823 ميلادي بغداد، الدولة العباسية |
| الوفاة | جمادى الأولى 281 هجري ق. 894 ميلادي بغداد، الدولة العباسية |
| مكان الدفن | مقبرة الشيخ معروف، الشونيزية[1] |
| الإقامة | بغداد، |
| الكنية | أبو بكر[2] |
| اللقب | المُحَدِّث، المُؤَدِّب |
| الديانة | الإسلام |
| المذهب الفقهي | حنبلي |
| الطائفة | أهل السنة والجماعة |
| العقيدة | أهل الحديث (أهل الأثَر) |
| الأب | محمد بن عبيد بن سفيان |
| الحياة العملية | |
| العصر | العصر العباسي الأول والثاني |
| تعلم لدى | أحمد بن حنبل، محمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهم |
| المهنة | مدرس، ومؤرخ، وراوي حديث |
| اللغات | العربية |
| مجال العمل | الحديث، الفقه |
| أعمال بارزة | الإخلاص والنية (كتاب)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كتاب)، والتوبة (كتاب)، والشكر لله (كتاب)، والأولياء (كتاب)، والزهد لابن أبي الدنيا |
| تعديل مصدري - تعديل | |
أبو بكر، عبد الله بن محمد بن عبيد(1) بن سفيان بن قيس، القرشي(2)، البغدادي (208 هـ[3] - جمادى الأولى[4] 281 هـ[5]) المُلقَّب بـ ابن أبي الدنيا (وقد طغى لقبه على اسمه حتى اشتهر به). الإمام، الحافظ، المحدِّث، العالم،[6] الصَّدوق،[7] الزاهد، المُؤدِّب. وُلد في مدينة بغداد، في أوائل القرن الثالث للهجرة سنة 208 هـ. نشأ في بيت عِلم، فأبوه من رُوَّاةِ الأخبار وقد بدأ في طلب العلم قبل بُلوغ سِنِّ العاشرة.[8](3)
عصره[عدل]
الحياة السياسية في عصره[عدل]
عاصر ابن أبي الدنيا عددا من خلفاء بني العباس، مؤدِّبا اثنين منهم؛ المعتضد بالله (توفي 289 هـ) والمكتفي بالله (توفي 295 هـ). وتوفي خلال فترة خلافة المُعتضد بالله. والخلفاء الذين عاصرهم هم على التوالي: المأمون (198—218 هـ)، المعتصم بالله (218—227 هـ)، الواثق بالله (227—232 هـ)، المتوكل على الله (232—247 هـ)، المنتصر بالله (247—247 هـ)، المستعين بالله (248—252 هـ)، المعتز بالله (252—255 هـ)، المهتدي بالله (255—256 هـ)، المعتمد على الله (256—279 هـ)، ثم المعتضد بالله (279—279 هـ). وكان هذا العصر الذي توالَى فيه الخلفاء على هذا المِنوال وبهذا العدد خلال هذه الفترة الوجيزة، هو عصرٌ ذو أهمية بالغة من حيث الأحداث السياسية التي وقعت فيه (فتوحات إسلامية، تناحر بين أفراد الأسرة العباسية الحاكمة، دخول الأعاجم في سِلك الدولة ثم التحكُّم في شؤونها، الثورات الداخلية في البلاد، تسلط رجال الفِرَق الضالة على بعض الخلفاء وحَملِهِم على القول بآرائهم، إغارةُ الأعداء على أراضي المسلمين.. إلخ).
بالجملة عاصر ابن أبي الدنيا دولة بني العباس بشِقَّيها؛ فترة القوة منذ ولادته حتى عام 247 هـ، ثم فترة الضعف منذ عام 247 هـ حتى وفاته.[9]
الحياة الاجتماعية في عصره[عدل]
الاستقرار والتقدم الاجتماعي يرتبط بشكل كبير بالاستقرار السياسي ويتأثر به. فمن حيث طبقات المجتمع كان هناك تباينٌ بين أفراده في عصر ابن أبي الدنيا، ويُلاحَظ وجود ثلاث فِئات رئيسية؛
- الطبقة الخاصة: كانت تتكون من الأُسرَة الحاكمة ورجال الدولة وأبناء البُيوتات العريقة، إضافة إلى فئة الجُند الأتراك. وهي فئة تتميز بالثراء الفاحش والتَّرَف، الذي يظهر من خلال القصور الفخمة التي تمَّ تشييدها آنذاك، وكأنها مدنٌ خاصة.[10]
- الطبقة العامة: تضم الرعية على اختلاف أنسابهم ومهنهم (أصحاب حِرف، علماء، أُدباء، أطباء وغيرهم). وكان منهم فئة تقربوا إلى الخلفاء وأصحاب النفوذ سواءً لعلومهم أو ثقافتهم، وكانت مهمتهم هي تأديب وتثقيف أبناء الطبقة الخاصة، وهذه الفئة كانت تُسمى بالمؤدبين.[11] ومنهم ابن أبي الدنيا الذي كان مؤدبًا لبعض أبناء الخلفاء.
- طبقة الرقيق: وتضم المماليك والعبيد والجواري، وهي طبقة تكونت نتيجة الفتوحات الإسلامية.[12]
ومن طراز المعيشة في تلك الفترة اختلاف الملبس باختلاف الجنس أو الطبقة الاجتماعية. فللقضاء زيٌّ، ولأصحاب القُضاةِ زيٌّ، وللشُّرَط زيٌّ، وللكُتَّاب زيٌّ، ولكُتَّاب الجُند زيٌّ.[13] كما اعتاد أهل ذلك العصر على الاحتفال ببعض أيام السنة زيادة على عيدي المسلمين (الأضحى والفطر)، مثل رأس السنة الهجرية وأول الربيع والمهرجان وغيرها.[14] تنامت الرياضة ووسائل اللهو في تلك الفترة، ومن أبرز أنواع الرياضة التي اهتمَّ بها الناس آنذاك: الفروسية، كرة الصولجان، الصيد، تربية الطيور والحيوانات، الشطرنج والنرد، السباحة والمصارعة.[15] وقد عارضَ عددٌ من الشيوخ والأئمة انصراف البعض إلى اللهو، ومن أولئك الأئمة ابن أبي الدنيا حيث صنَّف أجزاء حديثيَّة هامة في هذا الشأن أبرزها كتاب ذم الملاهي.
الحياة العلمية في عصره[عدل]
يُعدّ القرن الثالث الهجري العصر العِلمِيّ الذهبي في التاريخ الإسلامي، وقد أُتيح لـ ابن أبي الدنيا أن يَشهَد ويعيش عصرًا ازدحم بالعبقريات والموهوبين في شتَّى فنون الفكر. ففي علوم القرآن صُنّفت عدة كتب في مجال التفسير، على رأسها تفسير الطبري لمؤلفه محمد بن جرير الطبري، ومنها ما صنَّفه ابن أبي الدنيا في قراءة شيخه أبي محمد خلف بن هشام، سمَّاه "حروف خلف".[16] وأما في علوم الحديث فكان ذلك عصر تأليف وصدور أمهات كُتب الحديث المعروفة باسم الكتب الستة، وظهور طرق أخرى في التصنيف كمسند الإمام أحمد ابن حنبل، وانتهج ابن أبي الدنيا منهجًا مُستقِلاً في التخصص من خلال كُتب الرجال والعِلَل. ومن ناحية الفقه وأصوله، الذي تفرَّع منذ القرن الثاني الهجري إلى طريقة أصحاب الحديث وطريقة أصحاب الرأي، والذي انتهى مع نهاية القرن الثالث الهجري باقتصار الناس على تقليد أئمة الفقه. وفي مجال العقيدة وعلم الكلام كلٌّ صنَّف بحسب اعتقاده. إلى غير ذلك من مُختلف العلوم الأخرى كاللغة والتأريخ والطب وغيرهم.

تزامنًا مع هذا الانتعاش العلميّ الكبير، ومنذ تولي المأمون الخلافة سنة 198 هجري، تمت ترجمة أغلب كتب الفلاسفة اليونانيين وكتب الطب والرياضيات والفلك وغيرها. لذلك اعتنى الخلفاء خاصة والعلماء عامة بجمع الكتب، ومن الخزائن العامة المُشتَهر في ذلك الزمان بيت الحكمة. قال الذهبي: «ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من أئمة الحديث النبوي خلق كثير وما ذكرنا عشرهم هنا وأكثرهم مذكورون في تاريخي، وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول...».[17]
عقيدته ومذهبه[عدل]
مذهبه العقدي[عدل]
لم ينُصَّ ابن أبي الدنيا عن عقيدته صراحة، فلا يوجد له كتاب في العقيدة. ولكن من خلال النصوص التي نقلَها يتَّضح أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة حيث أنه عاصر محنة خلق القرآن ولم يُنقل عنه أنه وقف مع القائلين بذلك. كما أنه صنَّف عناوينَ لكتبه توافق معتقد هذه الطائفة مثل: كتاب الأهوال، صفة الجنة، صفة النار، صفة الصراط، القبور، وغيرها.
مذهبه الفقهي[عدل]
كان ابن أبي الدنيا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فقد ذكره المصنِّفون في طبقات الحنابلة في مؤلفاتهم،[18][19] كما نقلو له مسألتين شافهَ بهما الإمام أحمد، وهما:
- قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: ما أقول بين التكبيرتين في صلاة العيد؟ قال: تحمد الله عز وجل، وتصلي على النبي.
- قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا:سألت أحمد بن حنبل: متى يُصلًّى على السقط؟ فقال: إذا كان لأربعة أشهر صلِّ عليه، وسمِّ.
شيوخه[عدل]

في مُجمل مراجع كتب أهل السنة والجماعة نجد ما مجموعُه 992 شيخًا لابن أبي الدنيا. ذَكر الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال في ترجمة ابن أبي الدنيا 124 شيخًا.[20] وذكر الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء جُملة من مشايخهِ، منهم 58 شيخًا لم يذكُرهم المزي. ثم قال الذهبي: «ويَروي عن خلق كثير لا يُعرفونَ».[21]
من أشهر شيوخه:
- محمد بن عبيد بن سفيان مولى بني أمية، والد ابن أبي الدنيا. قال الخطيب: «روى عنه ابنه أبو بكر أحاديث مستقيمة».[22]
- أحمد بن محمد بن حنبل، نزيل بغداد وأحد الأئمة الأربعة. رغم نفي الإمام الذهبي[23] والصفدي[24] سماعه منه إلا أن الأدلة كثيرة في روايته عنه والمُثبت مقدَّم على النافي.[25][26][19][18]
- أبو جعفر محمد بن الحسين، المعروف بـ أبي شيخ البرجلاني.[8]
- زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد الثقة الثبت.
- القاسم بن سلاَّم البغدادي أبو عبيد.
- محمد بن إسماعيل البخاري، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث.
- خلف بن هشام بن ثعلب البزار، المُقرئ البغدادي.
- علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، ثقة ثبت رمي بالتشييع.
تلاميذه[عدل]

من أهم الأسباب في توافر التلاميذ الذين رووا عنه ورواية مصنَّفاته؛ كثرة مروياته التي زادت عن 12 ألف خبرًا بالمُكرَّر. ومن أهم تلاميذه:
- أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وابنه، جالساه وكتبا عنه.[2]
- المحدِّث أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي الأصبهاني اللنباني، ارتحل وسَمع كثيرًا من ابن أبي الدنيا، (توفي سنة 332 هـ).[27]
- المحدِّث الفقيه مفتي وشيخ العراق أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي النجاد، (توفي سنة 384 هـ).[28]
- المحدِّث أبو علي الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم البرذعي، صاحب ابن أبي الدنيا وراوي كُتبه، (توفي سنة 340 هـ).[29]
- المحدِّث المُسنَد أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن جميل البغدادي، استوطن سمرقند وروى بها الكثير عن ابن أبي الدنيا، (توفي سنة 346 هـ).[30]
- الإمام العلامة الأخباريّ أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام المحولي البغدادي الآجري، (توفي سنة 309 هـ).[31]
أقوال العلماء فيه[عدل]
اتفق العلماء على توثيق ابن أبي الدنيا وإمامته في فن الزهد والرقائق، مع أدبه وعلمه في السِّيَر والأخبار، وفصاحة أشعاره. وهي صِفاتٌ جعلت الخليفة يختاره لتأديب بَنِيه. روى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن ابن أبي الدنيا: «دخل المكتفي على الموفق ولوحه بيده، فقال: ما لك لوحك بيدك؟ قال: مات غلامي واستراح من الكتاب. قال: ليس هذا من كلامك هذا كان الرشيد أمر أن يعرض عليه ألواح أولاده في كل يوم اثنين وخميس، فعرضت عليه، فقال لابنه: ما لغلامك ليس لوحك معه؟ قال: مات واستراح من الكتاب قال: وكأن الموت أسهل عليك من الكتاب؟! قال: نعم. قال: فدع الكتاب، قال: ثم جئته، فقال لي: كيف محبتك لمؤدبك؟ قال: كيف لا أحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله، وهو مع ذاك إذا شئت أضحكك، وإذا شئت أبكاك قال: يا راشد أحضرني هذا، قال: فأحضرت فقربت حتى قربت من سريره، وابتدأت في أخبار الخلفاء، ومواعظهم فبكى بكاء شديدا، قال: فجاءني راغب أو يانس، فقال لي: كم تبكي أمير المؤمنين، فقال: قطع الله يدك ما لك وله يا راشد تنح عنه. قال: فابتدأت فقرأت عليه نوادر الأعراب، قال: فضحك ضحكا كثيرا، ثم قال لي: شهرتني شهرتني، وذكر الخبر بطوله، قال أبو ذر: فقال لأحمد بن محمد بن الفرات: أجر له خمسة عشر دينارا في كل شهر، قال أبو ذر: فكنت أقبضها لابن أبي الدنيا إلى أن مات».[32] وقال ابن أبي الدنيا: «وكنت أؤدب المكتفي، فأقرأته يوماً كتاب الفصيح فأخطأ فقرصت خده قرصة شديدة وانصرفت، فلحقني رشيق الخادم فقال: يقال لك ليس من التأديب سماع المكروه، فقلت: سبحان الله! أنا لا أسمع المكروه غلامي ولا أمتي، قال: فخرج إلي ومعه كاغذ وقال: يقال لك صدقت يا أبا بكر، وإذا كان يوم السبت تجيء على عادتك، فلما كان يوم السبت جئت فقلت: أيها الأمير، تقول عني ما لم أقل؟ قال: نعم يا مؤدبي، من فعل ما لم يجب قيل عنه ما لم يكن».[2]
ثناء العلماء عليه[عدل]
- قال ابن أبي حاتم: «سُئِل أبي عنه، فقال: بغداديّ صَدُوق».[7][1]
- قال ابن النديم: «كان وَرِعًا زاهِدًا عالمًا بالأخبار والروايات».[33]
- قال ابن الجوزي: «كان ذا مروءةٍ ثِقَةً صدوقًا».[34]
- قال ابن الأثير: «صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة».[35]
- قال السمعاني: «كان ثِقَةً صَدوقًا، مُكثِرًا من التصانيف في الزهد والرقائق».[36]
- قال المزي: «الحافظ صاحب التصانيف المشهورة المفيدة».[37]
- قال الذهبي: «المحدث العالم الصَّدوق».[6] وقال: «كان صَدوقًا أديبًا أخباريًّا كثير العلم».[38]
- قال ابن القيم: «وكان يُقال: ابن أبي الدنيا مَلأَ الدُّنيا عِلمًا».[39]
- قال ابن كثير: «الحافظ المصنف في كل فنٍّ المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة الذائِعة في الرقائق وغيرها... وكان صَدوقًا حافظًا ذا مُروءةٍ».[40]
- قال ابن حجر: «صدوقٌ حافظٌ صاحب تصانيف».[41] وقال أيضًا: «الحافظ صاحب التصانيف المشهورة».[42]
- قال ابن تغري بردي: «كان عالمًا زاهدًا وَرِعًا عابدًا، وله التصانيف الحِسان، والناس بعده عِيال عليه في الفنون التي جمعها، وروى عنه خلقٌ كثيرٌ اتَّفقوا على ثِقته وصِدقِه وأمانته».[43]
- قال السيوطي: «الحافظ صاحب التصانيف المشهورة المفيدة... وثِقة أبو حاتم وغيره».[44]
- قال الصفدي: «هو أحد الثِّقاتِ المُصنِّفين للأخبار والسِّيَر».[24]
- لما مات ابن أبي الدنيا قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «رحم الله أبا بكر مات معه عِلمٌ كثيرٌ».[1]
مؤاخذات أهل العلم عليه[عدل]
- روايته عن محمد ابن إسحاق البلخي؛ قال أبو يعلى النسفي: «سألت أبا علي صالح بن محمد عن ابن أبي الدنيا فقال: صدوق وكان يختلف معنا إلا أنه كان يسمع من إنسان يقال له: محمد بن إسحاق بلخي وكان يضع للكلام إسنادًا، وكان كذابًا، يروى أحاديث من ذات نفسه مناكير».[1] روى ابن أبي الدنيا عنه حديثان فقط في «كتاب الإخوان» (حديث رقم 34
 ) و«كتاب مُجَابو الدعوة» (حديث رقم 53
) و«كتاب مُجَابو الدعوة» (حديث رقم 53  ).
). - روايته عن محمد ابن إسحاق الصِّيني؛ قال ابن الجوزي: «قد روى ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق بن يزيد بن عبيد الله الصيني، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الكذابين، وقد ذكرنا وفاته في سنة ست وثلاثين ومائتين، وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق اللؤلؤي البلخي، ولم يكن بثقة، وقد ذكرنا وفاته في سنة أربع وأربعين ومائتين».[34] لكن لم تُنشر أية رواية لابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق الصِّيني فيما طُبع من مصنَّفاته.
- تركه الأخذ عن عفان بن مُسلِم؛ روى الخطيب البغدادي بسنده عن إبراهيم الحربي قال: «رحم الله أبا بَكْر بن أبي الدُّنيا، كنّا نمضي إلى عفّان نسمعُ منه، فنرى ابن أبي الدُّنيا جالسًا مع محمد بن الحُسين البُرْجُلاني، خَلْفَ شريجة (سقيفة من سَعَف) بقَّال، يكتُب عنه، ويدَع عفّان».[8][45][1][46] بيدَ أنَّ ابن أبي الدنيا لم يترك السَّماع من عفَّان آنذاك رفضًا له، وإنما لكونه مشغوفًا بأخبار الزُّهد والرقائق. قال ابن الجوزي: «كان يقصد أحاديث الزهد والرقائق، وكان لأجلها يكتب عن البرجلاني، ويترك عفان بن مسلم».[47] كما أنه روى عنه بواسِطَة في «كتاب إصلاح المال» (حديث رقم 237 و362
 ) و«كتاب التواضع والخمول» (حديث رقم 163 و194
) و«كتاب التواضع والخمول» (حديث رقم 163 و194  ) و«كتاب العقوبات» (حديث رقم 144
) و«كتاب العقوبات» (حديث رقم 144  ) و«كتاب المرض والكفارات» (حديث رقم 119
) و«كتاب المرض والكفارات» (حديث رقم 119  )، وغيرهم.
)، وغيرهم. - روايته عن خلق لا يُعرَفون وعن المتأخرين؛ قال الذهبي: «يروي عن خلق كثير لا يُعرفون، وعن طائفة من المتأخرين».[48] أما الرواية عن خلق لا يُعرفون فهي روايات موقوفة.
- قليل الترحال في طلب العلم؛ قال الذهبي: «كان قليل الرحلة، فيتعذر عليه رواية الشيء، فيكتبه نازلاً وكيف اتَّفق».[48] وأما الرواية عن المتأخرين فهو رأي يتعارض مع ما قاله البخاري: «لا يكون المحدث كاملاً حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه».[49]
مؤلفاته[عدل]
قال عنها الذهبي في السير: «تصانيفه كثيرة جدًا، فيها مخبآت وعجائب» وسرد منها أكثر من 160 تصنيف. وقد صدرت الكثير من الطبعات « التجارية » غير العلمية التي أهملت السَّمَاعات مما جعلها تقع في تحريف وسقط غير يسير.
تم إيجاد أسماء مصنفاته في مخطوط قديم في المكتبة العمرية مجموع 42 (ق56—59) بخط الحافظ المُزِّي الذي ذكر له فيه 167 كتابًا[وب 1] وبعد تحقيق من الدكتور صلاح الدين المنجد توصَّل إلى أن عدد كتبه يبلغ 174 كتابًأ[وب 2] وأسماءهم:
- أخبار أُويس.
- أخبار الجفاة عند الموت.
- أخبار الخلفاء.
- أخبار سفيان (أو: أخبار الثوري).
- أخبار ضيغم.
- أخبار قريش.
- أخبار معاوية.
- أخبار الملوك.
- الإخوان (أو: الإخوان والمعاطف).
- الإخلاص والنية.
- الأخلاق.
- الأدب.
- الأشراف.
- اصطناع المعروف.
- إصلاح المال.
- الأضاحي (أو: الأضحية).
- الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان.
- الأعراب (أو: أخبار الأعراب).
- إعطاء السائل.
- الألحان.
- الألوية.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- الأموال (أو: إصلاح المال).
- إنزال الحاجة بالله.
- انقلاب الزمان.
- الأنواء.
- الأهوال (أو: أهوال القيامة).
- الأولياء أو: كرامات الأولياء).
- البعث.
- التاريخ.
- تاريخ الخلفاء.
- تزويج فاطمة رضي الله عنها.
- التشمس.
- التعازي.
- تغير الإخوان.
- تغيير الزمان.
- التفكر والاعتبار.
- التقوى.
- التهجد وقيام الليل.
- التواضع والخمول.
- التوبة.
- التوكل.
- الجهاد.
- الجوع.
- الجيران.
- الحذر والشفقة.
- حروف خَلَف.
- حسن الظن بالله.
- الحلم (أو: الحلم وذم الفحش).
- حلم الأحنف بن قيس.
- حلم الحلماء.
- حلم معاوية.
- الحوائج (أو: قضاء الحوائج).
- الحيوان.
- الخاتم.
- الخائفين.
- الخلفاء.
- الخير.
- الدعاء.
- دلائل النبوة.
- الدَّيْن (أو: الدين والوفاء).
- الذِّكْر.
- ذكر الموت (أو: الموت).
- ذم البخل.
- ذم البغي.
- ذم الحسد.
- ذم الدنيا (طُبع مرة بتصرف من المحقق ياسين السوَّاس باسم: الزُّهد).
- ذم الربا.
- ذم الرياءي.
- ذم الشهوات.
- ذم الضحك.
- ذم الفقر.
- ذم المسكر.
- ذم الملاهي.
- الرخصة في السماع.
- الرضا عن الله بقضائه.
- الرقائق.
- الرقة والبكاء.
- الرمي.
- الرهائن.
- الرهبان.
- الرؤيا (أو: تعبير الرؤيا).
- الزفير.
- الزهد.
- زهد مالك بن دينار.
- السبق.
- السخاء.
- سدرة المنتهى.
- السنة.
- سواد الشيب.
- شجرة طوبى.
- شرف الفقر.
- الشكر.
- الصبر.
- الصدقة.
- صدقة الفطر.
- صفة الجنة.
- صفة الصراط.
- صفة الميزان.
- صفة النار.
- صفة النبي ﷺ.
- الصمت وآداب اللسان.
- الصلاة على النبي ﷺ.
- الطبقات.
- الطواعين.
- العزلة والانفراد.
- العفو وذم الغضب.
- العقل وفضله.
- العقوبات.
- عقوبة الأنبياء.
- العلم.
- العمر والشيب.
- العوابد.
- العوذ.
- العيال.
- العيدين.
- الغيبة والنميمة (أو: ذم الغيبة).
- الفتوى.
- الفرج بعد الشدة.
- فضائل رمضان.
- فضائل العباس.
- فضائل عشر ذي الحجة.
- فضائل علي.
- فضائل القرآن.
- فضائل لا إله إلا الله.
- فضل عاشوراء.
- الفنون.
- الفوائد.
- القبور.
- قرى الضيف.
- القصاص.
- قصر الأمل.
- قضاء الحوائج.
- القناعة والتعفف.
- القيامة.
- كلام الليالي والأيام لابن آدم (أو: الليالي والأيام).
- المتمنين.
- مجابو الدعوة.
- المجوس.
- محاسبة النفس.
- المحتضرين.
- مداراة الناس.
- المرض والكفارات.
- المروءة.
- المطر والرعد والبرق والريح.
- معاريض الكلام (أو: معارض الكلام).
- المعيشة.
- المغازي.
- مقتل الحسين.
- مقتل الزبير.
- مقتل سعيد بن جبير.
- مقتل طلحة.
- مقتل عبد الله بن الزبير.
- مقتل عثمان.
- مقتل علي بن أبي طالب.
- مقتل عمر.
- مكارم الأخلاق.
- مكائد الشيطان.
- المملوكين.
- المناسك.
- المنامات.
- من عاش بعد الموت.
- المنتظم.
- مواعظ الخلفاء.
- النوادر.
- النوازع والرعاية.
- الهدايا.
- الهم والحزن.
- الهواتف.
- الوجل والتوثق من العمل.
- الورع.
- الوصايا.
- الوقف والابتداء.
- اليقين.
وفاته[عدل]
اختلف أهل العلم في وفاته على أربعة أقوال:
القول الأول[عدل]
أنه توفي سنة 280 هـ. نقل هذا الخطيب البغدادي في تاريخه، والسمعاني في الأنساب. حكم الخطيب على هذا القول بالوهم،[50] وقال السمعاني: «وهذا غلط».[45]
القول الثاني (الراجح)[عدل]
أنه توفي سنة 281 هـ في شهر جمادى الأولى، عن 73 سنة. وهو قول ابن النديم،[33] والخطيب،[50] ابن أبي يعلى، والسمعاني، وابن الأثير، والمزي، والذهبي، ابن كثير، وابن حجر، والسيوطي، وابن تغري بردي، وابن مفلح، والخزرجي، والصفدي على الشَّك.
وهذا القول هو قول الجمهور ممن ترجم له. إلا أن ابن النديم قال: «توفي يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين».[33]
القول الثالث[عدل]
أنه توفي سنة 282 هـ. وهو قول ابن شاكر الكتبي، والصفدي على الشَّك.
القول الرابع[عدل]
أنه كان حيًّا سنة 289 هـ، وهو قول صاحب كتاب «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور»، حيث قال: «أخبرنا إجازة، أنبأنا أبو الفضل عبد الصمد بن محمد بن محمد بن عيسى العاصمي البلخي بها، حدثنا أبو سليمان حمد ابن محمد الخطابي البستي، حدثني عبد الله بن موسى، عن ابن أبي الدنيا قال: لما أفضت الخلافة إلى المكتفي كتبت له بيتين:
». قال السيوطي: «وهذا يدل على تأخر ابن أبي الدنيا إلى أيام المكتفي». وقد تولى المكتفي الخلافة سنة 289 هـ.
هوامش[عدل]
- 1 عُبيد: جاء في خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ما نصه «عبد الله بن محمد بن عَبيدة (بالفتحة) ابن سفيان الأموي ...».[51] إلا أن كل من ترجم لابن أبي الدُّنيا (أزيد من 20 مؤلف) قال: ابن عُبيد (بالضمَّة). ويُعتبر أصحَّ لأنه قول الجمهور.
- 2 القُرشي: قيل له القرشي لأنه مولى بَني أُمَيّة.
- 3 دون سن العاشرة: وجه الدلالة أن عفان بن مسلم تغير حفظه في شهر صفر سنة 219 هـ. فيكون سنّ ابن أبي الدنيا زمن مقالة إبراهيم الحربي ما بين 10 و11 سنة على الأكثر. وذكره دليل على أن ابن أبي الدنيا كان معروفا بالطلب زمن المقالة فعلى ذلك يكون عمره أقل من عشر سنوات حسن بدأ في طلب العلم. والله أعلم.
المراجع[عدل]
إحالات المراجع[عدل]
كُتب ومنشورات[عدل]
- ^ ا ب ج د ه المزي (1980)، ج. 16، ص. 77.
- ^ ا ب ج د ابن شاكر (1974)، ج. 2، ص. 229.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 13، ص. 397.
- ^ الطريقي (2001)، ج. 1، ص. 152.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 13، ص. 404.
- ^ ا ب الذهبي (1998)، ج. 2، ص. 181.
- ^ ا ب ابن أبي حاتم (1952)، ج. 5، ص. 163.
- ^ ا ب ج البغدادي (2001)، ج. 11، ص. 294.
- ^ شاكر (2000)، ج. 6، ص. 3.
- ^ عبد الباقي (1991)، ص. 46—48.
- ^ الكروي (1989)، ص. 86—88.
- ^ عبد الباقي (1991)، ص. 50—59.
- ^ الجاحظ (2002)، ج. 3، ص. 78.
- ^ عبد الباقي (1991)، ص. 91—93.
- ^ عبد الباقي (1991)، ص. 95—101.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 13، ص. 402.
- ^ الذهبي (1998)، ج. 2، ص. 150.
- ^ ا ب ابن مفلح (1990)، ج. 2، ص. 51.
- ^ ا ب ابن أبي يعلى (1952)، ج. 1، ص. 192—195.
- ^ المزي (1980)، ج. 16، ص. 72—75.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 13، ص. 397—399.
- ^ البغدادي (2001)، ج. 3، ص. 644.
- ^ الذهبي (1990)، ج. 21، ص. 206.
- ^ ا ب الصفدي (2000)، ج. 17، ص. 281.
- ^ ابن أبي الدنيا (1993)، ص. 95.
- ^ ابن أبي الدنيا (1990)، ج. 2، ص. 597.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 15، ص. 311.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 15، ص. 503.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 15، ص. 442.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 15، ص. 547.
- ^ الذهبي (1985)، ج. 14، ص. 264.
- ^ البغدادي (2001)، ج. 11، ص. 293/294.
- ^ ا ب ج ابن النديم (1978)، ص. 262.
- ^ ا ب ابن الجوزي (1992)، ج. 12، ص. 341.
- ^ ابن الأثير (2005)، ص. 1090.
- ^ السمعاني (1988)، ج. 4، ص. 471.
- ^ المزي (1980)، ج. 16، ص. 72.
- ^ الذهبي (1960)، ج. 2، ص. 71.
- ^ ابن القيم (2019)، ج. 1، ص. 243.
- ^ ابن كثير (1990)، ج. 11، ص. 71.
- ^ ابن حجر (1995)، ص. 542.
- ^ ابن حجر (1908)، ج. 6، ص. 12.
- ^ ابن تغري (1963)، ج. 3، ص. 86.
- ^ السيوطي (1983)، ص. 298/299.
- ^ ا ب السمعاني (1988)، ج. 4، ص. 472.
- ^ ابن حجر (1908)، ج. 6، ص. 13.
- ^ ابن الجوزي (1992)، ج. 5، ص. 142.
- ^ ا ب الذهبي (1985)، ج. 13، ص. 399.
- ^ ابن حجر (2001)، ص. 503.
- ^ ا ب البغدادي (2001)، ج. 11، ص. 295.
- ^ الخزرجي (1884)، ص. 213.
وب[عدل]
- ^ الحافظ المزي (29 أغسطس 2012). "أسماء مصنفات ابن أبي الدنيا على حروف المعجم للحافظ المزي". www.alukah.net. مؤرشف من الأصل في 2023-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-30.
- ^ المنجد، صلاح الدين (13 سبتمبر 2012). "معجم مصنفات ابن أبي الدنيا". www.alukah.net. مؤرشف من الأصل في 2023-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-30.
بيانات المراجع[عدل]
- صفي الدين الخزرجي (1884)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (ط. 1)، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، OCLC:63663323، QID:Q119626603
- ابن حجر العسقلاني (1908)، تهذيب التهذيب، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، OCLC:878030290، QID:Q116971729
- ابن أبي حاتم (1952)، الجرح والتعديل (دائرة المعارف العثمانية، 1952م) (ط. 1)، بيروت، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، دار الكتب العلمية، OCLC:122789034، QID:Q119627962
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: ref duplicates default (link) - ابن أبي يعلى (1952)، طبقات الحنابلة، تحقيق: محمد حامد الفقي، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، OCLC:784456356، QID:Q116983967
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: ref duplicates default (link) - شمس الدين الذهبي (1960)، العبر في خبر من غبر ويليه ذيول العبر، تحقيق: صلاح الدين المنجد، عَمَّان: دائرة المطبوعات والنشر، OCLC:1033869191، QID:Q126902356
- ابن تغري (1963)، النُّجُوم الزَّاهرة في مُلُوك مصر والقاهرة، القاهرة: وزارة الثقافة المصرية، OCLC:4771215703، QID:Q116767481
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: ref duplicates default (link) - ابن شاكر (1974)، فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار صادر، OCLC:4770206154، QID:Q120998496
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: ref duplicates default (link) - النديم (1978)، الفهرست، تحقيق: إبراهيم رمضان (ط. 1)، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، OCLC:24647816، QID:Q121001589
- جمال الدين المزي (1980)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف (ط. 1)، بيروت: مؤسسة الرسالة، OCLC:235963978، QID:Q113613903
- جلال الدين السيوطي (1983)، طبقات الحفاظ (ط. 1)، بيروت: دار الكتب العلمية، OCLC:745128458، QID:Q126902731
- شمس الدين الذهبي (1985)، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مجموعة (ط. 1)، بيروت: مؤسسة الرسالة، OCLC:4770539064، QID:Q113078038
- أبو سعد السمعاني (1988)، الأنساب، مراجعة: عبد الله عمر البارودي (ط. 1)، بيروت: دار الجنان، OCLC:1107150923، QID:Q126892745
- إبراهيم سلمان الكروي (1989)، طبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي الأول (ط. 2)، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، OCLC:21937930، QID:Q124050740
- شمس الدين الذهبي (1990)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري (ط. 2)، بيروت: دار الكتاب العربي، OCLC:784341033، QID:Q114917343
- ابن مفلح (1990)، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، الرياض: مكتبة الرشد، OCLC:236029910، QID:Q116984282
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: ref duplicates default (link) - ابن أبي الدنيا (1990)، العيال، تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، الدمام: دار ابن القيم، ASIN:B078NDP197، OCLC:949502878، QID:Q119632319
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: ref duplicates default (link) - ابن كثير الدمشقي (1990)، البداية والنهاية (ط. 2)، بيروت: مكتبة المعارف، OCLC:1014061270، QID:Q115624184
- أحمد عبد الباقي (1991-05)، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري (ط. 1)، مركز دراسات الوحدة العربية، OCLC:26756991، QID:Q124050012
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(مساعدة) - أبو الفرج بن الجوزي (1992)، المُنتظم في تاريخ المُلُوك والأُمم، مراجعة: نعيم زرزور. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا (ط. 1)، بيروت: دار الكتب العلمية، OCLC:25457932، QID:Q114811014
- ابن أبي الدنيا (1993)، إصلاح المال، تحقيق: محمد عبد القادر عطا (ط. 1)، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، OCLC:1103732527، QID:Q119630655
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: ref duplicates default (link) - ابن حجر العسقلاني (1995)، تقريب التهذيب، تحقيق: أبو الأشبال الباكستاني (ط. 1)، الرياض: دار العاصمة، OCLC:47698091، QID:Q117084598
- شمس الدين الذهبي (1998). تذكرة الحفاظ. تحقيق: زكريا عميرات (ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية. ISBN:978-2-7451-2217-9. OCLC:875751264. OL:22371791M. QID:Q113637996.
- صلاح الدين الصفدي (2000)، الْوافِي بالْوَفَيَات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، تركي فرحان المصطفى (ط. 1)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، OCLC:713922056، QID:Q113528574
- محمود شاكر (2000)، التاريخ الإسلامي (ط. 8)، المكتب الإسلامي، OCLC:1158722179، QID:Q123238338
- ابن حجر العسقلاني (2001). هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: عبد القادر شيبة أحمد (ط. 1). الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. ISBN:9960-20-819-2. OCLC:4771282720. QID:Q126908391.
- الخطيب البغدادي (2001)، تاريخ بغداد، تحقيق: بشار عواد معروف (ط. 1)، بيروت: دار الغرب الإسلامي، OCLC:49659164، QID:Q114815356
- عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي (2001). معجم مصنفات الحنابلة من وفيات 241- 1420هـ (ط. 1). الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. ISBN:9960-39-261-9. OL:13210417M. QID:Q116994896.
- الجاحظ (2002)، البيان والتبيين، بيروت: دار ومكتبة الهلال، OCLC:968777261، QID:Q114648059
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: ref duplicates default (link) - ابن الأثير الجزري (2005)، الكامل في التاريخ، تاريخ ابن الأثير الجزري، مراجعة: أبو صهيب الكرمي، عَمَّان: بيت الأفكار الدولية، OCLC:122745941، QID:Q123225171
- ابن قيم الجوزية (2019). طريق الهجرتين وباب السعادتين. آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. مراجعة: سعود بن عبد العزيز العريفي، علي العمران. إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي، زائد بن أحمد النشيري. الرياض، بيروت: دار عطاءات العلم، دار ابن حزم. ISBN:978-9959-857-80-4. QID:Q115796818.
| ابن أبي الدنيا في المشاريع الشقيقة: | |
| |